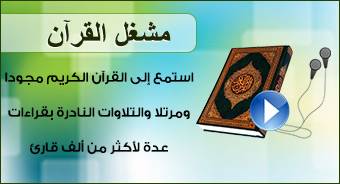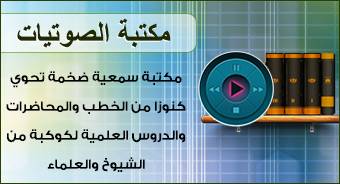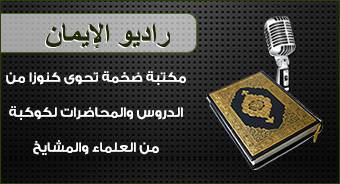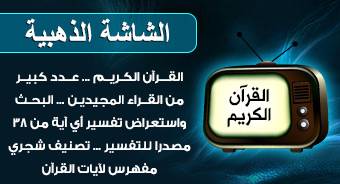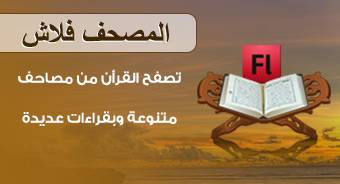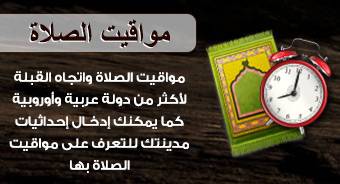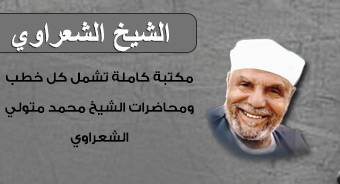|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم
والوَداعُ: اسمٌ من التَّوْدِيع، قال القَطامىّ: أَراد ولا يَكُنْ مِنكِ مَوْقِف الوَداعِ، ولكن لِيَكُنْ مَوْقِف غِبْطَةٍ وإِقامة، لأَنَّ موقفَ الوَدع يكون للفِراق، ويكون مُنَغَّصاً بما يَتْلُوه من التَبارِيحِ والشَّوْق.وقولهم: دَعْ ذَا، أَى اتْرُكْه، وأَصلهُ وَدَعَ يَدَعُ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «دَعْ ما يَريبك».قال عَمْرُو بن مَعْدِيكرب: قال اللغويون: أُمِيتَ ماضِيهِ، لا يُقال: وَدَعَهُ إِنَّما يُقال تَركَه ولا واجِعٌ ولكن تَارِكٌ.قالوا: ورُبَّما جاءَ في ضرورة الشِّعر وَدَعَه وهو مَوْدُوع على أَصْلِه، قال أَنَسُ بن زُنَيْم: وقال سُوَيْدُ بن أَبى كاهِل اليَشْكُرِىّ يصفُ نَفْسه: وقال آخر: وقد اختارَ النبي صلى الله عليه وسلم أَصلَ هذه اللغة فيما رَوَى عنه ابنُ عبّاسٍ رضى الله عنهما أَنَّه قرأ: {ما وَدَّعَك رَبُّكَ وما قلى} بتخفيف الدَّال، وكذلك قرأ بهذه القراءة عُرْوة ومُقاتل وأَبو حَيْوَةَ، وأَبو البَرَهْسَم وابنُ أَبِى عَيْلَةَ ويَزِيدُ النَّحْوَىّ.وقال صلى الله عليه وسلم: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقوامٌ عن وَدْعِهِم الجُمُعات أَوْ لَيَخْتِمَنَّ الله على قُلُوبهم ثمّ لَيكُونُنَّ من الغافِلين».وقرأ الباقون {ما وَدَّعك} بالتشديد، أَى ما تَرَكك من اخْتارَك، ولا أَبْغَضَك منذ أَحَبَّك.وفى الحديث: «إِذا لم يُنْكِرِ الناسُ المُنْكَرَ فقد تُوُدِّع منهم» أَى أُسْلِمُوا إِلى ما استحقُّوه من المنكر عليهم، وتُرِكُوا وما استَحبُّوه، من المَعاصى حتى يُكْثِرُوا منها فيَستوجِبُوا العقوبةَ.وفى الحديث: «دَعْ داعِىَ اللَّبَن» أَى اتركْ منه في الضَرْع شيئا يَسْتَنْزِلُ اللَّبَنَ.ووادَعَ بَنِى فُلان: صالَحَهُم.والتَّوْديع عند الرّحيل معروفٌ، وهو تخليف المسافِرِ الناسَ خافِضين وادِعين، وهم يُوَدِّعُونَه إِذا سافَر تَفاؤلاً بالدَّعَة التي يصير إِليها إِذا قَفَل، أَى يتركونه وَسَفَره، قال الأَعشى: واستَوْدَعْتُه وَديعَةً: استْحْفَظْتُه إِيّاها قال: وقوله تعالى: {فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ} أَى مستودَعٌ في الصلب في وقيل في الثَّرَى.والمُسْتَوْدَعُ في قول عبّاس بن عبد المطَّلب رضى الله عنه: المكانُ الذي جُعِلَ فيه آدم وحَوّاءُ عليهما السلام من الجنَّة واستُودعاهُ، وقيل: الرَّحمُ. اهـ.
فما زال يردد هذا عند البيت حتى أتاه أبو جهل على ناقة وبين يديه محمد وهو يقول: لا ندري ماذا نرى من ابنك، فقال عبد المطلب ولم؟ قال: إني أنخت الناقة وأركبته من خلفي فأبت الناقة أن تقوم، فلما أركبته أمامي قامت الناقة، كأن الناقة تقول: يا أحمق هو الإمام فكيف يقوم خلف المقتدى! وقال ابن عباس: رده الله إلى جده بيد عدوه كما فعل بموسى حين حفظه على يد عدوه ورابعها: أنه عليه السلام لما خرج مع غلام خديجة ميسرة أخذ كافر بزمام بعيره حتى ضل، فأنزل الله تعالى جبريل عليه السلام في صورة آدمي، فهداه إلى القافلة، وقيل: إن أبا طالب خرج به إلى الشأم فضل عن الطريق فهداه الله تعالى وخامسها: يقال: ضل الماء في الليل إذا صار مغموراً، فمعنى الآية كنت مغموراً بين الكفار بمكة فقواك الله تعالى حتى أظهرت دينه وسادسها: العرب تسمي الشجرة الفريدة في الفلاة ضالة، كأنه تعالى يقول: كانت تلك البلاد كالمفازة ليس فيها شجرة تحمل ثمر الإيمان بالله ومعرفته إلا أنت، فأنت، شجرة فريدة في مفازة الجهل فوجدتك ضالا فهديت بك الخلق، ونظيره قوله عليه السلام: «الحكمة ضالة المؤمن» وسابعها: ووجدك ضالا عن معرفة الله تعالى حين كنت طفلاً صبياً، كما قال: {والله أَخْرَجَكُم مّن بُطُونِ أمهاتكم لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئًا} [النحل: 78] فخلق فيك العقل والهداية والمعرفة، والمراد من الضال الخالي عن العلم لا الموصوف بالاعتقاد الخطأ وثامنها: كنت ضالا عن النبوة ما كنت تطمع في ذلك ولا خطر شيء من ذلك في قلبك، فإن اليهود والنصارى كانوا يزعمون أن النبوة في بني إسرائيل فهديتك إلى النبوة التي ما كنت تطمع فيها ألبتة وتاسعها: أنه قد يخاطب السيد، ويكون المراد قومه فقوله: {وَوَجَدَكَ ضالا} أي وجد قومك ضلالاً، فهداهم بك وبشرعك وعاشرها: وجدك ضالا عن الضالين منفرداً عنهم مجانباً لدينهم، فكلما كان بعدك عنهم أشد كان ضلالهم أشد، فهداك إلى أن اختلطت بهم ودعوتهم إلى الدين المبين الحادي عشر: وجدك ضالا عن الهجرة، متحيراً في يد قريش متمنياً فراقهم وكان لا يمكنك الخروج بدون إذنه تعالى، فلما أذن له ووافقه الصديق عليه وهداه إلى خيمة أم معبد، وكان ما كان من حديث سراقه، وظهور القوة في الدين كان ذلك المراد بقوله: {فهدى}، الثاني عشر: ضالا عن القبلة، فإنه كان يتمنى أن تجعل الكعبة قبلة له وما كان يعرف أن ذلك هل يحصل له أم لا، فهداه الله بقوله: {فَلَنُوَلّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا} [البقرة: 144] فكأنه سمى ذلك التحير بالضلال الثالث عشر: أنه حين ظهرها له جبريل عليه السلام في أول أمره ما كان يعرف أهو جبريل أم لا، وكان يخافه خوفاً شديداً، وربما أراد أن يلقي نفسه من الجبل فهداه الله حتى عرف أنه جبريل عليه السلام الرابع عشر: الضلال بمعنى المحبة كما في قوله: {إِنَّكَ لَفِى ضلالك القديم} [يوسف: 95] أي محبتك، ومعناه أنك محب فهديتك إلى الشرائع التي بها تتقرب إلى خدمة محبوبك الخامس عشر: ضالا عن أمور الدنيا لا تعرف التجارة ونحوها،ثم هديتك حتى ربحت تجارتك، وعظم ربحت حتى رغبت خديجة فيك، والمعنى أنه ما كان لك وقوف على الدنيا، وما كنت تعرف سوى الدين، فهديتك إلى مصالح الدنيا بعد ذلك السادس عشر: {وَوَجَدَكَ ضالا} أي ضائعاً في قومك؛ كانوا يؤذونك، ولا يرضون بك رعية، فقوي أمرك وهداك إلى أن صرت آمراً والياً عليهم السابع عشر: كنت ضالا ما كنت تهتدي على طريق السموات فهديتك إذ عرجت بك إلى السموات ليلة المعراج الثامن عشر: ووجدك ضالا أي ناسياً لقوله تعالى: {أَن تَضِلَّ أحداهُمَا} [البقرة: 282] فهديتك أي ذكرتك، وذلك أنه ليلة المعراج نسي ما يجب أن يقال بسبب الهيبة، فهداه الله تعالى إلى كيفية الثناء حتى قال: «لا أحصي ثناء عليك» التاسع عشر: أنه وإن كان عارفاً بالله بقلبه إلا أنه كان في الظاهر لا يظهر لهم خلافاً، فعبر عن ذلك بالضلال العشرون: روى على عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يعملون به غير مرتين، كل ذلك يحول الله بيني وبين ما أريد من ذلك، ثم ما هممت بعدهما بسوء حتى أكرمني الله برسالته، فإني قلت ليلة لغلام من قريش، كان يرعى معي بأعلى مكة، لو حفظت لي غنمي حتى أدخل مكة، فأسمر بها كما يسمر الشبان، فخرجت أريد ذلك حتى أتيت أول دار من دور مكة، فسمعت عزفاً بالدفوف والمزامير، فقالوا فلان ابن فلان يزوج بفلانة، فجلست أنظر إليهم وضرب الله على أذني فنمت فما أيقظني إلا مس الشمس، قال فجئت صاحبي، فقال ما فعلت؟ فقلت ما صنعت شيئاً، ثم أخبرته الخبر، قال: ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك، فضرب الله على أذني فما أيقظني إلا مس الشمس، ثم ما هممت بعدهما بسوء حتى أكرمني الله تعالى برسالته».{وَوَجَدَكَ عائلا فأغنى (8)} ففيه مسائل:المسألة الأولى:العائل هو ذو العيلة، وذكرنا ذلك عند قوله: {أَن لا تَعُولُواْ} [النساء: 3] ويدل عليه قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً} [التوبة: 28] ثم أطلق العائل على الفقير، وإن لم يكن له عيال، وههنا في تفسير العائل قولان:الأول: وهو المشهور أن المراد هو الفقير، ويدل عليه ما روى أنه في مصحف عبد الله: {ووجدك عديماً} وقرئ {عيلاً} كما قرئ {سيحات}.ثم في كيفية الإغناء وجوه:الأول: أن الله تعالى أغناه بتربية أبي طالب، ولما اختلت أحوال أبي طالب أغناه الله بمال خديجة، ولما اختل ذلك أغناه الله بمال أبي بكر، ولما اختل ذلك أمره بالهجرة وأغناه بإعانة الأنصار، ثم أمره بالجهاد، وأغناه بالغنائم، وإن كان إنما حصل بعد نزول هذه السورة، لكن لما كان ذلك معلوم الوقوع كان كالواقع، روي أنه عليه السلام: «دخل على خديجة وهو مغموم، فقالت له مالك، فقال: الزمان زمان قحط فإن أنا بذلت المال ينفذ مالك فأستحي منك، وإن لم أبذل أخاف الله، فدعت قريشاً وفيهم الصديق، قال الصديق: فأخرجت دنانير وصبتها حتى بلغت مبلغاً لم يقع بصري على من كان جالساً قدامي لكثرة المال، ثم قالت: اشهدوا أن هذا المال ماله إن شاء فرقه، وإن شاء أمسكه».الثاني: أغناه بأصحابه كانوا يعبدون الله سراً حتى قال عمر حين أسلم: أبرز أتعبد اللات جهراً ونعبد الله سراً! فقال عليه السلام: «حتى تكثر الأصحاب،» فقال حسبك الله وأنا فقال تعالى: {حَسْبُكَ الله وَمَنِ اتبعك مِنَ المؤمنين} [الأنفال: 64] فأغناه الله بمال أبي بكر، وبهيبة عمر. الثالث: أغناك بالقناعة فصرت بحال يستوي عندك الحجر والذهب، لا تجد في قلبك سوى ربك، فربك غني عن الأشياء لا بها، وأنت بقناعتك استغنيت عن الأشياء، وإن الغنى الأعلى الغنى عن الشيء لا به، ومن ذلك أنه عليه السلام خير بين الغنى والفقر، فاختار الفقر الرابع: كنت عائلا عن البراهين والحجج، فأنزل الله عليك القرآن، وعلمك مالم تكن تعلم فأغناك.القول الثاني في تفسير العائل: أنت كنت كثير العيال وهم الأمة، فكفاك.وقيل فأغناهم بك لأنهم فُقراء بسبب جهلهم، وأنت صاحب العلم، فهداهم على يدك.وهاهنا سؤالات:السؤال الأول:ما الحكمة في أنه تعالى اختار له اليتم؟ قلنا فيه وجوه:أحدها: أن يعرف قدر اليتامى فيقوم بحقهم وصلاح أمرهم، ومن ذلك كان يوسف عليه السلام لا يشبع.فقيل له في ذلك: فقال أخاف أن أشبع فأنسى الجياع.وثانيها: ليكون اليتيم مشاركاً له في الاسم فيكرم لأجل ذلك، ومن ذلك قال عليه السلام: «إذا سميتم الولد محمداً فأكرموه، ووسعوا له في المجلس»وثالثها: أن من كان له أب أو أم كان اعتماده عليهما، فسلب عنه الولدان حتى لا يعتمد من أول صباه إلى آخر عمره على أحد سوى الله، فيصير في طفوليته متشبهاً بإبراهيم عليه السلام في قوله: حسبي من سؤالي، علمه بحالي، وكجواب مريم: {أنى لَكِ هذا قالتْ هُوَ مِنْ عِندِ الله} [آل عمران: 37].ورابعها: أن العادة جارية بأن اليتيم لا تخفى عيوبه بل تظهر، وربما زادوا على الموجود فاختار تعالى له اليتيم، ليتأمل كل أحد في أحواله، ثم لا يجدوا عليه عيباً فيتفقون على نزاهته، فإذا اختاره الله للرسالة لم يجدوا عليه مطعناً وخامسها: جعله يتيماً ليعلم كل أحد أن فضيلته من الله ابتداء لأن الذي له أب، فإن أباه يسعى في تعليمه وتأديبه وسادسها: أن اليتم والفقر نقص في حق الخلق، فلما صار محمد عليه الصلاة والسلام، مع هذين الوصفين أكرم الخلق، كان ذلك قلباً للعادة، فكان من جنس المعجزات.السؤال الثاني:ما الحكمة في أن الله ذكر هذه الأشياء؟الجواب: الحكمة أن لا ينسى نفسه فيقع في العجب.السؤال الثالث:روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «سألت ربي مسألة وددت أني لم أسألها، قلت: اتخذت إبراهيم خليلاً، وكلمت موسى تكليماً، وسخرت مع داود الجبال، وأعطيت سليمان كذا وكذا، وأعطيت فلاناً كذا وكذا، فقال: ألم أجدك يتيماً فآويتك؟ ألم أجدك ضالا فهديتك؟ ألم أجدك عائلا فأغنيتك؟قلت: بلى.فقال: ألم أشرح لك صدرك؟قلت: بلى، قال: ألم أرفع لك ذكرك؟قلت: بلى! قال: ألم أصرف عنك وزرك؟قلت: بلى، ألم أوتك مالم أوت نبياً قبلك وهي خواتيم سورة البقرة؟ أم أتخذك خليلاً كما اتخذت إبراهيم خليلاً؟» فهل يصح هذا الحديث.قلنا: طعن القاضي في هذا الخبر فقال: إن الأنبياء عليهم السلام لا يسألون مثل ذلك إلا عن إذن، فكيف يصح أن يقع من الرسول مثل هذا السؤال.ويكون منه تعالى ما يجري مجرى المعاتبة.{فَأَمَّا اليتيم فَلَا تقهر (9)}وقرئ {فلا تكهر}، أي لا تعبس وجهك إليه، والمعنى عامله بمثل ما عاملتك به، ونظيره من وجه: {وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ الله إِلَيْكَ} [القصص: 77] ومنه قوله عليه السلام: «الله الله فيمن ليس له إلا الله» وروي: أنها نزلت حين صاح النبي صلى الله عليه وسلم على ولد خديجة ومنه حديث موسى عليه السلام حين: «قال: إلهي بم نلت ما نلت؟ قال: أتذكر حين هربت منك السخلة، فلما قدرت عليها قلت: أتعبت نفسك ثم حملتها، فلهذا السبب جعلتك وليا علي الخلق»، فلما نال موسى عليه السلام النبوة بالإحسان إلى الشاة فكيف بالإحسان إلى اليتيم، وإذا كان هذا العتاب بمجرد الصياح أو العبوسية في الوجه، فكيف إذا أذله أو أكل ماله، عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا بكى اليتيم وقعت دموعه في كف الرحمن، ويقول تعالى: من أبكى هذا اليتيم الذي واريت والده التراب، من أسكته فله الجنة».{وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تنهر (10)}يقال: نهره وانتهره إذا استقبله بكلام يزجره، وفي المراد من السائل قولان:أحدهما: وهو اختيار الحسن أن المراد منه من يسأل العلم ونظيره من وجه: {عَبَسَ وتولى أَن جَاءهُ الأعمى} [عبس: 1، 2] وحينئذ يحصل الترتيب، لأنه تعالى قال له أولاً: {أَلَمْ يَجِدْكَ يتيماً فآوى وَوَجَدَكَ ضالا فهدى وَوَجَدَكَ عائلا فأغنى} [الضحى: 6- 8] ثم اعتبر هذا الترتيب، فأوصاه برعاية حق اليتيم، ثم برعاية حق من يسأله عن العلم والهداية، ثم أوصاه بشكر نعم الله عليه والقول.الثاني: أن المراد مطلق السائل ولقد عاتب الله رسوله في القرآن في شأن الفُقراء في ثلاثة مواضع أحدها: أنه كان جالساً وحوله صناديد قريش، إذ جاء ابن أم مكتوم الضرير، فتخطى رقاب الناس حتى جلس بين يديه، وقال: علمني مما علمك الله، فشق ذلك عليه فعبس وجهه فنزل {عَبَسَ وتولى} [عبس: 1].والثاني: حين قالت له قريش: لو جعلت لنا مجلساً وللفُقراء مجلساً آخر فهم أن يفعل ذلك فنزل قوله: {واصبر نَفْسَكَ مَعَ الذين يَدْعُونَ رَبَّهُم} [الكهف: 28] والثالث: كان جالساً فجاءه عثمان بعذق من ثمر فوضعه بين يديه فأراد أن يأكل فوقف سائل بالباب، فقال: رحم الله عبداً يرحمنا، فأمر بدفعه إلى السائل فكره عثمان ذلك، وأراد أن يأكله النبي عليه السلام فخرج واشتراه من السائل، ثم رجع السائل ففعل ذلك ثلاث مرات، وكان يعطيه النبي عليه السلام إلى أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أسائل أنت أم بائع؟» فنزل: {وَأَمَّا السائل فَلاَ تنهر}.{وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فحدث (11)}وفيه وجوه:أحدها: قال مجاهد: تلك النعمة هي القرآن، فإن القرآن أعظم ما أنعم الله به على محمد عليه السلام، والتحديث به أن يقرأه ويقرئ غيره ويبين حقائقه لهم.وثانيها: روي أيضاً عن مجاهد: أن تلك النعمة هي النبوة، أي بلغ ما أنزل إليك من ربك.وثالثها: إذا وفقك الله فراعيت حق اليتيم والسائل، وذلك التوفيق نعمة من الله عليك فحدث بها ليقتدي بك غيرك، ومنه ما روي عن الحسين بن علي عليه السلام أنه قال: إذا عملت خيراً فحدث إخوانك ليقتدوا بك، إلا أن هذا إنما يحسن إذا لم يتضمن رياء، وظن أن غيره يقتدي به، ومن ذلك لما سئل أمير المؤمنين على عليه السلام عن الصحابة فأثنى عليهم وذكر خصالهم، فقالوا له: فحدثنا عن نفسك فقال: مهلاً، فقد نهى الله عن التزكية فقيل له: أليس الله تعالى يقول: {وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبّكَ فحدث} فقال: فإني أحدث، كنت إذا سئلت أعطيت وإذا سكت ابتديت، وبين الجوانح علم جم فاسألوني.فإن قيل: فما الحكمة في أن أخر الله تعالى حق نفسه عن حق اليتيم والعائل؟.قلنا: فيه وجوه:أحدها: كأنه يقول أنا غني وهما محتاجان وتقديم حق المحتاج أولى.وثانيها: أنه وضع في حظهما الفعل ورضي لنفسه بالقول.وثالثها: أن المقصود من جميع الطاعات استغراق القلب في ذكر الله تعالى، فجعل خاتمة هذه الطاعات تحدث القلب واللسان بنعم الله تعالى حتى تكون ختم الطاعات على ذكر الله، واختار قوله: {فحدث} على قوله فخبر، ليكون ذلك حديثاً عنده لا ينساه، ويعيده مرة بعد أخرى، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم. اهـ.
|